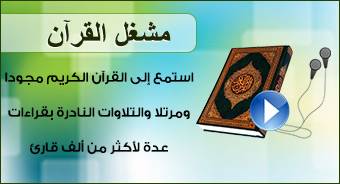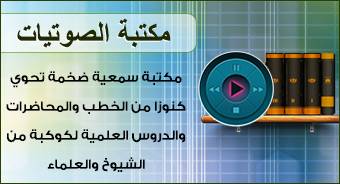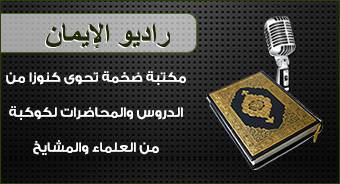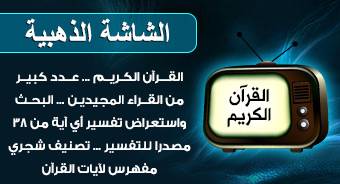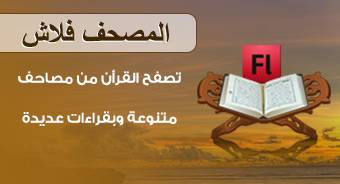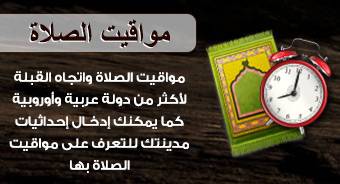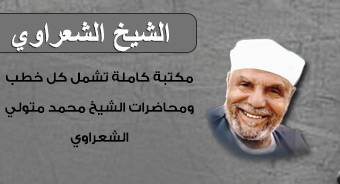|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وكأنه عَلَى هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسي، ويحتمل أن يكون أشار للقول الثاني من كلام المتيطي إذ قَالَ: واختلف فِي الحذقة، فذهب بعض أهل العلم أنّه لا حذقة عَلَيْهِ للمؤدب بحكم أن لا تكون بشرط ويكون معلوماً، وقاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم، وذهب غيره إِلَى أن يحمل ذلك عَلَى سُنة البلد، فإن جرت عادتهم بذلك حكم بها، ويقضى له بها عند ابن حبيب بقدر ما يرى عَلَى حفظ القرآن ظاهراً أو نظراً، وإِن كَانَ يخطيء فِي الحرف والحرفين، وإِذَا حسن خطّه وهجاؤه، وكتب كل ما يملى عَلَيْهِ وقرأ جلّ ما رآه وجب عَلَيْهِ حذقته نظراً. انتهى. ومراده بالحذقة الختمة.متن الخليل:وإِجَارَةُ مَاعُونٍ كَقَصْعَةٍ، وقِدْرٍ، وعَلَى حَفْرِ بِئْرٍ إِجَارَةً، وجَعَالَةً، وكُرِهَ حَلْيٌ.الشرح:قوله: (وَإِجَارَةُ مَاعُونٍ كَقَصْعَةٍ، وقِدْرٍ) كذا فِي "المدونة"، وفِي نقل المصنف له بمثاليه تنكيت عَلَى ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدر، شهادة منه بأنهما لا يعرفان بعد الغيبة عَلَيْهِمَا.متن الخليل:وكُرِهَ حَلْيٌ كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِمِثْلِهِ أَوْ لَفْظٍ، وتَعْلِيمِ فِقْهٍ، وفَرَائِضَ كَبَيْعِ كُتُبِهِ، وقِرَاءَةٌ بِلَحْنٍ، وكِرَاءُ دُفٍّ، ومِعْزَفٍ لِعُرْسٍ.الشرح:قوله: (كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِمِثْلِهِ) كذا فِي بعض النسخ بزيادة الثوب كما فِي "المدونة". فهو صواب.متن الخليل:وكِرَاءُ لِعِيدِ كَافِرٍ، وبِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْكِرَاءِ، وسُكْنَى فَوْقَهُ.الشرح:قوله: (وكِرَاءُ لِعِيدِ كَافِرٍ) كذا فِي بعض النسخ بإدخال لام الجرّ عَلَى العيد، واحد الأعياد مضافاً لكافر، وفِي بعضها: (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد، وإدخال لام الجرّ عَلَى الكافر، وكلاهما صحيح، وقد قَالَ فِي باب الذكاة: (وَإِلاَّ كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ، وبَيْعٍ، أو إِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ).متن الخليل:بِمَنْفَعَةٍ.الشرح:قوله: (بِمَنْفَعَةٍ) يدلّ أنّ ما تجرّد عن المنفعة غير جائز كما قَالَ ابن يونس فيمن قَالَ: اطلع هذا الجبل ولك كذا، ولكن هذا من باب: الجعل، وقد قَالَ بعد هذا: (وفِي شرط منفعة الجاعل قَوْلانِ).متن الخليل:تَتَقَوَّمُ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْداً، ولا حَظْرٍ، وتَعَيُّنٍ، ولَوْ مُصْحَفاً.الشرح:قوله: (تَتَقَوَّمُ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْداً، ولا حَظْرٍ، وتَعَيُّنٍ) أصله للغزالي. قال ابن عَرَفَة: تبع ابن شاس وابن الحَاجِب الغزالي، فشرطا أن تكون متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدوراً عَلَى تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة، ففسروا متقومة بما لها قيمة، وهو قول الغزالي: عنينا بالمتقوم أن استئجار تفاحةً للشمّ والطعام لتزيين الحوانيت لا يصحّ، فإنه لا قيمة له، وعبّر ابن عَرَفَة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين، وأن يقدر عَلَى تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلها، ولفظ تعين فِي كلام المصنف مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَى المنفي أي: بلا استيفاء عين ولا حظر ولا تعين.وهو تحرير لقولهم: ولا واجبة، إذ مقتضاه أن المنع معلق عَلَى تعين العبادة لا عَلَى وجوبها، ولا يلزم من تعيّن العبادة وجوبها؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوتر، وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَفَة، فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وإِن لَمْ تكن واجبة لتعينها عَلَى المكلف، ومعنى تعينها: أنها لا يصحّ وقوعها من غير من خوطب بها، فلو أجيز الاستئجار عَلَيْهَا لأدى إِلَى أكل المال بالباطل. قاله ابن عبد السلام.متن الخليل:وأَرْضَاً غَمَرَ مَاؤُهَا، ونَدَرَ انْكِشَافُهُ.الشرح:قوله: (وأَرْضَاً غَمَرَ مَاؤُهَا، ونَدَرَ انْكِشَافُهُ) هذا قول ابن القاسم فِي "المدونة"، وفِي سياقه فِي حيّز الإغياء تعريض بابن الحَاجِب المقتصر فيه عَلَى قول غير ابن القاسم.متن الخليل:وشَجَراً لِتَجْفِيفٍ عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ.الشرح:قوله: (وَشَجَراً لِتَجْفِيفٍ عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ) تسليم لوجود الخلاف، وقد قَالَ ابن عَرَفَة تبع ابن الحَاجِب ابن شاس فِي قوله: فِي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِ، وقبله شارحاه، ولا أعرف القول بالمنع، ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبّ مرحاض وحائط لحمل خشب.متن الخليل:لا لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا، واغْتُفِرَ مَا فِي الأَرْضِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ بِالتَّقْوِيمِ، ولا تَعْلِيمِ غِنَاءٍ، أَوْ دُخُولِ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ، أَوْ دَارٍ لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ، وتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ، وبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الأَرْجَحِ.الشرح:قوله: (لا لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا) (لأخذ) معطوف عَلَى تجفيف، وَ(شاة) بالنصب معطوف عَلَى شجراً، وأشار بهذا لقول ابن شاس، فلا يصحّ استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود. قال ابن عَرَفَة وتبعه ابن الحَاجِب، ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب فِي الإجارات لوضوح حكمه من البياعات، وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى.وأما ابن عبد السلام فسلّم الثمرة والنِّتَاج والصوف، وبحث فِي اللبن فقال: أما استئجارها للبن فالمذهب أنّه لا يمتنع مُطْلَقاً، وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَازَ بشرط تعدد الشياة وكثرتها، وإِن كَانَ عَلَى الكيل لَمْ يحتج إِلَى هذا الشرط، وإجارة الشاة لأجل لبنها قصاراه أن يؤدي إِلَى بيع لبنها، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى.واستوفي فِي "التوضيح" شروط الجواز المعروفة، ومن جملتها أن يكون فِي الأبان، ثم حمل كلام ابن الحَاجِب عَلَى ما إِذَا لَمْ يكن فِي الأبان كما فِي الثمرة والصوف. انتهى.وهو بيّن من تعليل ابن شاس بأنه بيع عينٍ قبل الوجود.متن الخليل:وَلا مُتَعَيِّنٍ كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، بِخِلافِ الْكِفَايَةِ.الشرح:قوله: (ولا مُتَعَيِّنٍ كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكور، ونبّه بركعتي الفجر عَلَى ما هو أحرى منها.متن الخليل:وعُيِّنَ مُتَعَلِّمٌ، ورَضِيعٌ، ودَارٌ، وحَانُوتٌ وبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ، ومَحْمِلٌ، إِنْ لَمْ تُوصَفْ، ودَابَّةٌ لِرُكُوبٍ وإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ، ونَوْعٌ وذُكُورَةٌ، ولَيْسَ لِرَاعٍ رَعْيُ أُخْرَى، إِنْ لَمْ يَقْوَ، إِلا بِمُشَارِكٍ، أَوْ تَقِلَّ، ولَمْ يَشْتَرِطْ خِلافُهُ، وإِلا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ، ولَمْ يَلْزَمْهُ رَعْيُ الْوَلَدِ، إِلا لِعُرْفٍ.الشرح:قوله: (وعُيِّنَ مُتَعَلِّمٌ، ورَضِيعٌ، ودَارٌ، وحَانُوتٌ وبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ، ومَحْمِلٌ، إِنْ لَمْ يُوصَفْ) كذا فِي بعض النسخ، وفِي بعضها: وإِن يوصف، فيمكن رجوعه لجميعها، عَلَى أن البناء عَلَى جدار لا يكون إِلا بوصف. قال فِي " التوضيح": (المَحْمِلٌ) بفتح الميم الأولى وكسر الأخيرة ـ وعلاقة السيف بالعكس.متن الخليل:وعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ ونَقْشِ الرَّحَا، وآلَةِ بِنَاءٍ.الشرح:قوله: (وعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ ونَقْشِ الرَّحَا، وآلَةِ بِنَاءٍ) أما الأخيران فصرّح بهما فِي "المدونة"، وأما الأول فقاله ابن شاس فقال ابن عَرَفَة: هو كقول "المدونة" فِي آلة البناء قَالَ: وعرفنا فِي الأجير ألاّ خيط عَلَيْهِ، وفِي الصانع الخيط عَلَيْهِ، وأما ابن عبد السلام فقال: لا يختلف فِي اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط عَلَى الخياط، إِلا أن يخاط الثوب بالحرير فيكون عَلَى مالك الثوب، وقريب منه فِي "التوضيح" فِي عرفهم بمصر.متن الخليل:وإِلا فَعَلَى رَبِّهِ.الشرح:قوله: (وإِلا فَعَلَى رَبِّهِ) أي وإِن لَمْ يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع من ثوبٍ ودقيق وجدار، هذا مقتضى كلامه، فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن الحَاجِب قائلاً عَلَى ما فِي النسخة الصحيحة: والخيط عَلَى الآجر ما لَمْ يكن عرف، بمدّ الهمزة من غير ياء بعد الجيم. والثالث صرّح بِهِ فِي "المدونة" قائلا: فإن لَمْ تكن لهم سنة فآلة البناء عَلَى ربّ الدار.وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا: ونقش الرحا عَلَى ربها، فلعلّ عرفهم أن ربّ الرحا هو ربّ الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر الكبير ممن تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها، وإلا فما هنا مخالف " للمدونة". والله تعالى أعلم.متن الخليل:عَكْسُ إِكَافٍ، وشِبْهِهِ وفِي السَّيْرِ والْمَنَازِلِ، والْمَعَالِيقِ، والزَّامِلَةِ، ووِطَائِهِ بِمَحْمِلٍ، وبَدَلِ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ، وتَوْفِيرِهِ.الشرح:قوله: (عَكْسُ إِكَافٍ، وشِبْهِهِ) أي: فإن كَانَ فيه عرف عمل بِهِ، وإِلا فهو عَلَى ربّ الدابّة، فالعكس حيث لا عرف ولَو كَانَ حيث لا عرف عَلَى المكتري كما فهم الشارح لكان مساوياً لما قبله لا عكساً له، فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن طريقة ابن شاس وابن الحَاجِب، وعوّل عَلَى ما أقيم من قوله فِي كتاب: الرواحل والدوابّ من "المدونة": ولا بأس أن تكتري من رجلٍ إبلا عَلَى أن عليك رحلتها، فإن ظاهره لولا الشرط لكان ذلك عَلَى ربّ الإبل، حكاه ابن عبد السلام، وإِن كَانَ قد بحث فيه.وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن الحَاجِب: وعَلَى مكري الدابّة البرذعة وشبهها، والإعانة فِي الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف. إذ مفهوم قوله: بالعرف أنّه لَو لَمْ يكن عرف لكان ذلك عَلَى المكتري، وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطّها أبين من تناوله للآكاف وشبهه أم هما سواء.وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحلّ الإبل وربطها والقيام بها، وزاد هو وابن عَرَفَة إقامة أخرى من قوله فِي رواحل "المدونة" أَيْضاً: وإِذَا اكتريت من رجلٍ إبله ثم هرب الجمّال وتركها فِي يدك فأنفقت عَلَيْهَا فلك الرجوع بذلك، وكذلك إِن اكتريت من يرحلها رجعت بكرائه. عَلَى أن أبا إسحاق التونسي النظار تأولها بما إِذَا كانت العادة أن ربّ الإبل هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَفَة: والأَظْهَر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة الحطّ والحمل؛ لما فِي سماع عيسى من ابن القاسم فيمن اكترى منزلاً فيه علو ولا سلم له، فقال لربه: اجعل لي سلماً له، فتوانى ولم ينتفع بِهِ المكتري حتى مضت السنة، أنّه يطرح عنه مناب العلو من الكراء. قال ابن رشد: لأنه باع منه منافع الدار فوجب أن يسلّمها له وإسلامه العلو هو بجعل السلم له والكراء فِي هذا بِخِلاف الشراء. ابن عَرَفَة: فالسلم للعلو كالبرذعة والسرج ونحوهما.متن الخليل:كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً، وهُوَأَمِينٌ، فَلا ضَمَانَ ولَوْ شُرِطَ إِثْبَاتُهُ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الْمَيِّتِ، أَوْ عَثَرَ بِدُهْنٍ، أَوْ طَعَامٍ بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ، ولَمْ يَتَعَدَّ. أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ. ولَمْ يَغُرَّ بِفِعْلٍ كَحَارِسٍ ولَوْ حَمَّامِيَّاً. وأَجِيرٍ لُصَانِعٍ وسِمْسَارٍ. إِنْ ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الأَزْهَرِ. ونُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلٍ سَائِغٍ. لا إِنْ خَالَفَ مَرْعًى شُرِطَ أَوْ أَنْزَى بِلا إِذْنٍ. أَوْ غَرَّ بِفِعْلٍ. فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ.أَوْ صَانِعٍ فِي مَصْنُوعِهِ. لا غَيْرِهِ.الشرح:قوله: (كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً) أي: وليلاً وإنما سكت عنه؛ لأنه أحرى قَالَ ابن عَرَفَة: وقول ابن شاس: إِذَا استأجر ثوباً للبس نزعه فِي أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة. صواب كقوله فِي "المدونة": من استأجر أجيراً للخدمة استعمله عَلَى عرف الناس من خدمة الليل والنهار. ابن عَرَفَة: فإن اختلف العرف فِي اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه.فرع:قال ابن عبد السلام: ومما يرجع فيه إِلَى العرف فِي هذا الباب فِي المكان كما رجع إليه هنا فِي الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى عَلَى متاع دواب إِلَى موضع وفِي الطريق نهر لا يجاز إِلا عَلَى المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه، فجواز المتاع عَلَى ربّه، والدوابّ عَلَى ربّها، وإِن كَانَ يخاض فِي المخائض، فاعترضه حملان لَمْ يعلم بِهِ، فحمل المتاع عَلَى صاحب الدابّة، وتلك جائحة نزلت بِهِ، وكذلك إِن كَانَ النهر شتوياً يحمل بالأمطار، إِلا أن يكون وقت الكراء قد علموا جريه، وعلى ذلك دخلوا، فيكون كالنهر الدائم. انتهى.ونقله ابن عات من " الاستغناء " عن بعض شيوخ الفتوى، قَالَ ابن عَرَفَة: انظر هذا الأصل مَعَ زيادة وزن حمل الدابّة بالمطر، يعني: هل بينهما تعارض؟متن الخليل:ولَوْ مُحْتَاجاً لَهُ عمَلٌ، وإِنْ بِبَيِّنَةٍ.أَوْ بِلا أَجْرٍ.إِنْ نَصَبَ نَفْسَهُ وغَابَ عَلَيْهِمَا. فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ. ولَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ. أَوْ دَعَا لأَخْذِهِ. إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ الأُجْرَةُ، إِلا أَنْ يُحْضِرَهُ لِرَبِّهِ بِشَرْطِهِ وصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ.الشرح:قوله: (ولَوْ مُحْتَاجاً لَهُ عَمَلٌ) لفظ عمل نائب عن الفاعل، وضبطه بعضهم: عملَ، بصيغة الفعل الماضي فردّه لما بعده، والأول أولى.متن الخليل:أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ، أَوْ قَلْعَ ضِرْسٍ.الشرح:قوله: (أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضمير، أشار بِهِ لقوله فِي "المدونة": ولَو قَالَ: ذبحتها ثم سرقت. صدّق، وهو أولى من منحورة بتاء التأنيث، إذ لا يدلّ عَلَى تعيين ناحرها.متن الخليل:أَوْ صِبْغ فَنُوزِعَ فِيهِ. وفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ، لا بِهِ إِلا صَبِيِّ تَعْلِيمٍ ورَضِيعٍ، وفَرَسِ نَزْوٍ، ورَوْضٍ، وسِنٍّ لِقَلْعٍ فَسَكَنَتْ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ، وبِغَصْبِ الدَّارِ، وغَصْبِ مَنْفَعَتِهَا، وأَمْرِ السُّلْطَانِ بِإِغْلاقِ الْحَوَانِيتِ، وحَمْلِ ظِئْرٍ، أَوْ مَرَضٍ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رِضَاعٍ ومَرَضِ عَبْدٍ وهَرَبِهِ لِكَعَدُوٍّ، إِلا أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقِيَّتِهِ بِخِلافِ مَرَضِ دَابَّةٍ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحُّ.الشرح:قوله: (أَوْ صِبْغ) بصيغة الفعل عطفاً عَلَى (ادعى). متن الخليل:وخُيِّرَ إِنْ تَبَيَّنَ أنّه سَارِقٌ.الشرح:قوله: (وخُيِّرَ إِنْ تَبَيَّنَ أنّه سَارِقٌ) لا يعارض قوله فِي المساقاة: وإِن ساقيته أو أكريته، فألفيته سارقاً لَمْ تفسخ؛ لأن معناه أكريته دارك.متن الخليل:وكَرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ إِلا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ، وبَقِيَ كَالشَّهْرِ كَسَفِيهٍ، ثَلاثَ سِنِينَ، وبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ آجَرَ، ومَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا عَلَى الأَصَحِّ، لا بِإِقْرَارِ الْمَالِكِ، أَوْ خُلْفِ رَبِّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ.أَوْ حَجٍّ وإِنْ فَاتَ مَقْصِدُهُ أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ، وآجَرَ الْحَاكِمُ، إِنْ لَمْ يَكُفَّ، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ وحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ.وَأُجْرَتُهُ لِسَيِّدِهِ، إِنْ أَرَادَ أنّه حُرٌّ بَعْدَهَا.الشرح:قوله: (و َكَرُشْدِ صَغِيرٍ) كذا فِي بعض النسخ بكاف التشبيه، وهو الصواب، وهو راجع للتخيير.
|